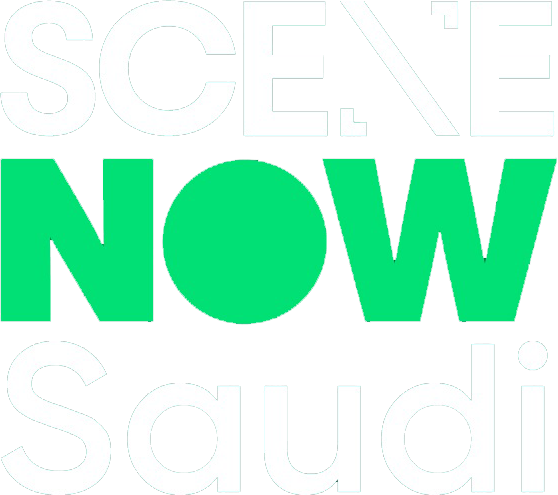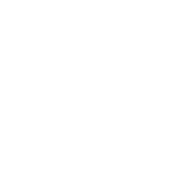البلد الوحيدة اللي عندها عيد للكحك وعيد للجوافة
أعياد كتير بتعدي في كل الدول زي بعض، بس إيه اللي بيميز دولة عن التانية، وشعب عن التاني؟ لمستهم الخاصة واحساسهم بالعيد ده واللي بيضيفوه ليه.
العالم كله مثلًا بيحتفل برمضان، بس "رمضان في مصر حاجة تانية" دي حقيقة أي مصري سافر بره أو أجنبي حضر رمضان هنا عارفها. ومن أكتر الحاجات المميزة اللي المصريين ضافوها للأعياد هي الأكل، كل عيد ليه عندنا أكلة مخصوصة. بقى عندنا عيد الكحك، وعيد الفسيخ، وعيد الفتة، حتى الجوافة ارتبطت بعيد.
والأكل اللي كان زمان مجرد متعة من متع الحياة، بقى فجأة رمز، وعلامة مميزة بتظهر في الأعياد والمناسبات. وهنا هنحكي إزاي الأكلات اتحولت من مجرد وصفات… لذكريات مرتبطة بأيام ما تتنسيش.
1- "عاشوراء".. في يوم عاشوراء، الحلو أصله منين؟

تعرف إن طبق "عاشوراء" أو "حلوى نوح" عليها حوارات أكتر بكتير من إنها شبه طبق البليلة؟
طبق "عاشوراء" اللي بناكله يوم 10 محرم -يوم عاشوراء- في ذكرى نجاة موسى النبي وشعبه من شر فرعون، عليه خلاف كبير إذا كان مصري ولا تركي.
الموضوع بدأ لما مصر قالت إن أصل الطبق بيرجع للدولة الفاطمية، وإنها في يوم من الأيام قررت تحتفل بيوم عاشوراء زي ما بتحتفل بالمولد النبوي الشريف، وليلة النصف من شعبان، وساعتها بدأ الفاطميين يعملوا طبق حلويات من القمح واللبن ويوزعوه .
لكن دي ماكنتش الرواية الوحيدة ففيه رواية تانية بتقول إن صلاح الدين الأيوبي وقت ما دخل مصر، قرر يخفي كل حاجة مرتبطة بعادات الدولة الفاطمية فمنع أنواع الحلوى اللي كان الفاطميين بيعملوها، وبدأ يستبدلها بأصناف حلوى جديدة كان من ضمنها طبق عاشوراء.
ومن الناحية التانية، فتركيا وتحديدًا الدولة العثمانية بتعتقد إن نوح –عليه السلام- هو أول من اخترع حلوى عاشوراء، وده وقت لما الأكل بدأ يخلص من السفينة، بدأ كل ركاب السفينة يجمعوا بقايا الطعام عشان يطبخوها ومن هنا جه اسم "حلوى نوح".
والحقيقة إن مفيش رواية تجزم إذا كانت "عاشوراء" فعلًا بيرجع أصلها لمصر ولا تركيا، بس الأكيد إن "عاشوراء" هتفضل مرتبطة معانا بأكلها وتوزيعها على الأهل والأصحاب والغرباء، باعتبارها رسالة محبة وسلام في أحد أيام الأشهر الحرم.
2- القلقاس في عيد الغطاس.. واللي ما ياكلش القلقاس يصبح من غير رأس!

رغم العداء الشهير بين القلقاس وشباب كتير من المصريين، إلا إن الإقبال عليه يوم 19 يناير –عيد الغطاس– بيكون رهيب، والسر مش بس في طعمه، لكن كمان في رمزيته الدينية. وأهمها:
القلقاس نبات درني، يعني بيكون مدفون في باطن الأرض، زي المُعمد اللي وقت تعميده بيتغطس في الميه. كمان القلقاس فيه مادة هلامية سامة مضرة للحنجرة، بس بتتحول لمادة نافعة مغذية بمجرد ما تختلط بالميه، والمُعمد –حسب الاعتقاد المسيحي– بيتطهر من "سموم" الخطية بالمعمودية.
والقلقاس علشان يتطبخ، بتتشال قشرته الخارجية وبعدين بيتسلق في الميه، وبرضه بالمعمودية، الإنسان بيتنقى من خطاياه. علشان كده، هتلاقي كل البيوت المسيحية يوم 19 يناير بيطبخوا قلقاس.
ومن ناحية تانية، القصب كمان مرتبط بعيد الغطاس، والمصريين بيرجعوا ده لأنه نبات طويل بيتزرع في الأماكن الحارة، فبقى رمز للحرارة الروحية والقامة العالية اللي المؤمن بيحاول يوصل لها، وعقلات القصب اللي على الساق بتشبه الفضائل اللي الإنسان بيكتسبها في مراحل حياته.
هل يا ترى الحاجات دي بدأت بسبب الرمزيات، ولا بعد ما أكلناها اخترعنا الرموز؟ محدش عارف. بس الأكيد إنها بقت مرتبطة في ذهن المصريين بالعيد.
3- فسيخ ورنجة وبصل وبيض ملون في شم النسيم..

تاريخ شم النسيم بيرجع لمصر القديمة، وقتها شم النسيم كان يُعرف باسم "عيد شمو" أو "شمو إيبِت"، وهو عيد كان يحتفل به المصريين ببداية فصل الربيع وتجديد الحياة والطبيعة بعد الشتاء. وكلمة "شمو" تعني موسم الحصاد أو البعث، وكان العيد مرتبط بموسم الفيضان.
كان المصريين القدماء يحتفلون بشمو بطقوس دينية واجتماعية، تبدأ من المعابد مثل "بر نيترو" (بيت الإله)، وتستمر بالخروج إلى الحدائق وتقديم الطعام والقرابين. ومن أهم مظاهر الاحتفال: تناول أطعمة رمزية زي السمك، البصل، والبيض.
الفسيخ هو السمك البوري المملح والمجفف. لما كانت مواسم الصيد قليلة في بداية الربيع، المصريين لجأوا لحفظ الأكل، وبدأوا يملّحوا ويجففوا السمك عشان يكلوه في مواسم مختلفة.
والسمك كان بيُعتبر رمز للتجدد والنماء القادم من نهر النيل، وكانت الأسماك تُخزن في جرار فخار خاصة.
البيض بيرمز لبداية الحياة أو خلق الحياة من الجماد حسب ما ورد في متون كتاب الموتى وأناشيد إخناتون؛ وتلوين البيض ارتبط بعادة قدماء المصريين، وهي نقش الدعوات والأمنيات على البيض، وبعدها يتعلق في شرفات المنازل أو أغصان أشجار الحدائق، عشان الأمنيات تتبارك بنور الإله عند شروقه فتتحقق.
أما البصل فكان بيرمز لطرد الأرواح الشريرة، وإرادة الحياة، والتغلّب على المرض، عشان كده الفراعنة كانوا بيعلقوه على الشرفات وفي المنازل، وحول رقابهم، وتحت الوسائد، ولحد دلوقتي فيه بيوت مصريين بيحطوا بصلة قدام باب البيت يوم شم النسيم الصبح.
أما الرنجة تعتبر عادة مستحدثة نسبيًا لإنها ماكنتش موجودة وقت الفراعنة، وظهرت بسبب الانفتاح على أوروبا، خصوصًا في القرنين الماضيين.
وتمر السنين وتعدي آلاف منها، وتتغير حاجات كتير بس يفضل المصريين كل شم نسيم يفطروا بيض وبعدها تشم ريحة الفسيخ والبصل جاية من كل البيوت بتقول إننا ولاد قدماء المصريين وبنحافظ على تراثهم.
4- الكنافة والقطايف في رمضان.. عصر ما قبل اختراع البيستاشيو.
قصة الكنافة بدأت في العصر الأموي، لما اشتكى الخليفة معاوية بن أبي سفيان من الجوع وقت الصيام، فنصحه طبيبه إنه يأكل أكل غني بالطاقة وقت السحور، فظهرت الكنافة وساعتها كانت معمولة مخصوص لتقوية الصايم، واتعرفت باسم "كنافة معاوية".
وفي العصر الفاطمي، بدأت الكنافة تنتشر في مصر، وكان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بيحرص إنه يوزع الكنافة والقطايف على الناس في رمضان، والناس استمروا على العادة دي لحد النهارده.
أما القطايف، فالناس ماتفقتش على قصة واحدة، يعني مثلًا في ناس بيقولوا إنها ظهرت في العصر العباسي، واتسمّت كده عشان الناس كانوا "يقطفوا" الحبة من الطبق بسرعة، ومن هنا جه اسمها. وناس تانية بتقول إنها بدأت في العصر الفاطمي كنوع من أنواع الحلويات اللي بتتقدم في شهر رمضان.
والمؤرخين نفسهم حبّوا الكنافة والقطايف، لدرجة إن جلال الدين السيوطي كتب عنهم رسالة اسمها "منهل اللطائف في الكنافة والقطايف"، وكمان الحملة الفرنسية لما كانت في مصر، رسمت أفران الكنافة في كتبها، عشان كانت جزء من حياة الناس اليومية في مصر اللي استمرت لحد النهارده.
5- طعمية وفول نابت ومحشي في الجمعة الحزينة.. أكلات اتجمعت على سفرة واحدة!
الجمعة العظيمة من أكتر الأيام روحانية في السنة عند المسيحيين، وهي الجمعة اللي بتسبق عيد القيامة وحسب الاعتقاد المسيحي فهي يوم صلب السيد المسيح.
الجمعة دي بتكون ضمن الصوم الكبير اللي مابيتأكلش فيه ولا ألبان ولا أسماك ولا أي منتجات حيوانية، وبتكون بس نباتية. ولأنها زي ما بيتقال عليها "الجمعة الحزينة" بيحاول المسيحين إنهم يعيشوا الحزن على صلب المسيح حتى في الأكل، وأحيانًا بتلاقي ناس بتشرب خل زي اللي شربه المسيح، لكن بعد صيام وانقطاع عن الأكل طول اليوم تقريبًا يومها بيرجع المسيحين عشان يلاقوا على السفرة نفس الطبق: فول نابت وطعمية ومحشي صيامي (من غير شوربة).
فيه تفسيرات كتير لده منها:
الفول النابت: بيرمز لحياة جديدة بتنبت بعد الفداء والصلب. الفول النابت طالع من بذرة ميتة، زي القيامة بعد الموت.
المحشي: بيشبه في رمزيته دفن السيد المسيح، خاصةً ورق العنب اللي بيتلف كأنه كفن.
الطعمية: مدوّرة زي الحجر اللي اتحط على باب القبر، رمز الصمت والانتظار قبل القيامة.
6- حلاوة المولد في المولد النبوي.. جربت تقول 10 اسامي حلويات في 30 ثانية؟
كل سنة، في 12 ربيع الأول، بتبدأ خناقة "مين هياخد إيه من علبة الحلاوة؟"، ووسط ما انت بتحاول تلحق آخر فولية بيجي في بالك سؤال هو إيه أصل الحكاية؟
الحكاية بدأت في عصر الدولة الفاطمية، وقتها كان في عادة سنوية إن موكب الخليفة بيعدي يوم المولد النبوي ويوزع حلويات بكميات كبيرة على الناس والجنود، وكانت الحلويات على شكل أحرف الهجاء العربية، وأشكال الحيوانات اللي بتعبر عن طبيعة حياتهم البدوية زي الحصان والجمل، وأشكال دينية زي القبة والمنارة، وطبعًا مع الوقت ومع توارث العادة دي على مر السنين المصريين قرروا يحطوا التاتش بتاعهم وضافوا انواع حلويات جديدة زي الملبن والحمصية والسمسمية والنوجا والفولية.
أما عن وجود عروسة وحصان المولد فالقصة بدأت لما الخليفة الفاطمي كان بيخرج في موكب المولد ومعاه زوجته، وكانت لابسة فستان أبيض مميز، فالناس بدأت تصنع عروسة من الحلوى تشبهها، ومعاها حصان حلاوة يرمز للفارس أو القائد.
7- كيس السبوع.. شيلني بحنية ده ماما تعبت فيا.

يمكن مكنش في آله "الهشتكة" عند المصريين القدماء، بس مع ذلك الفراعنة اهتموا أوي بتأسيس يوم السبوع للاحتفال بالمولود الجديد.
القصة بدأت لما كانت نسب وفيات الأطفال الرضّع عالية جدًا في الأيام الأولى بعد الولادة. فلو الطفل عدى أول سبع أيام، كانوا بيعتبروه "طفل الحظ" ويستحق احتفال كبير. وعلشان كده المصريين ما سابوش تفصيلة إلا وكان ليها معنى ورمز:
خطوة الأم فوق المولود سبع مرات: الطفل بيتحط في غربال، والأم بتخطي فوقه ٧ مرات، وده رمز لطرد الشر، زي ما الإلهة إيزيس أنقذت طفل آحد الفلاحات من سم العقرب بترديدها أسماء العقرب السبعة.
حمام السبوع: تقليد يعادل "التعميد"، وفيه يُغسل المولود بمياه طاهرة، زي ما كان المصري القديم بيُغسل في البحيرة المقدسة بالمعبد، في حضور الكاهن لتلاوة تعاويذ الحماية عشان ياخد البركة والخير والصحة.
الكحل، البخور، الحجاب: طقوس للحماية من الشر والحسد. بيكحلوا عيون الطفل لحمايته من الحسد، ويحرقوا البخور لطرد الأرواح الشريرة، ويلبسوه حجاب من القماش الأبيض علشان البركة والنقاء.
ووسط طقوس السبوع المختلفة من الزغاريط، والشموع، ودق الهون، بيظهر كيس صغير من الفول السوداني والحمص والفشار والملبس، عارفينه ومستنينه وهو كيس حلويات السبوع.
وزي ما كل طقس من طقوس السبوع كان ليه معنى وسبب فبردو اختيار الحلويات دي كان ليها سبب، فمثلًا:
الحمص رمز للخصوبة والنمو، والفول رمز للحياة الجديدة، والسوداني: عشان الطفل يطلع "ابن ناس" كريم وسخي، والملبس للفرحة، والسكر ارمز لحلاوة الحياة، والبلح رمز للطاقة والبركة.
Asmaa Gamal الصورة لـ
8- الفتة في عيد الاضحى.. يومها بندوق طعم العيد حرفيًا
في عيد الأضحى، مهما اختلفت العادات من بلد للتانية، في طبق واحد بيجتمع عليه الكل وهو الفتة اللي عبارة عن أكلة معمولة من عيش ومرقة ولحمة ورز، وكمصريين بنقعد نتخانق هي بصلصة ولا من غير؟
والفتة هي الطبق الرسمي للعيد باعتبارها أول أكلة من لحم الأضحية.
الأضحية، اللي هي الأساس في العيد، بتفكرنا بقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، لما افتدى ربنا الابن بكبش عظيم، فبقت اللحمة رمز للطاعة والتضحية.
9- بلح وجوافة في عيد النيروز... طعم الحياة من قلب الألم.
عيد النيروز هو رأس السنة القبطية، وبيتحفل بيه يوم 11 سبتمبر، واسم "نيروز" جاي من الكلمة القبطية "ني يارؤو" بمعنى الأنهار، في إشارة لفيضان النيل اللي كان بيبدأ في التوقيت ده.
والنيروز مش بس احتفال ببداية سنة زراعية جديدة، ده كمان بيخلّد ذكرى الشهداء الأوائل في المسيحية، وعلشان كده كان يُطلق على التقويم القبطي اسم "تقويم الشهداء"، وده خلّى أكلات العيد تكون رمزية جدًا.
فالبلح بلونه الأحمر بيمثل دم الشهداء، والنواة القوية جوا البلحة بترمز للإيمان الصلب في عز الاضطهاد، أما الألياف البيضا اللي جواها فبترمز لنقاء قلوبهم. والجوافة بلونها الأبيض من بره وجوه بيعبر عن نقاء وطهارة الشهداء.
كل مناسبة ليها أكلتها، وكل أكلة فيها حكاية، وبالحكاية بنحافظ على العادة، وننقلها، ونضيف عليها لمستنا.
وعشان كده، لما نقول "ريحة العيد"، أول حاجة بتيجي في بالنا مش الهدوم الجديدة... لكن ريحة الكحك، واللحمة واحيانًا حتى ريحة الفسيخ!